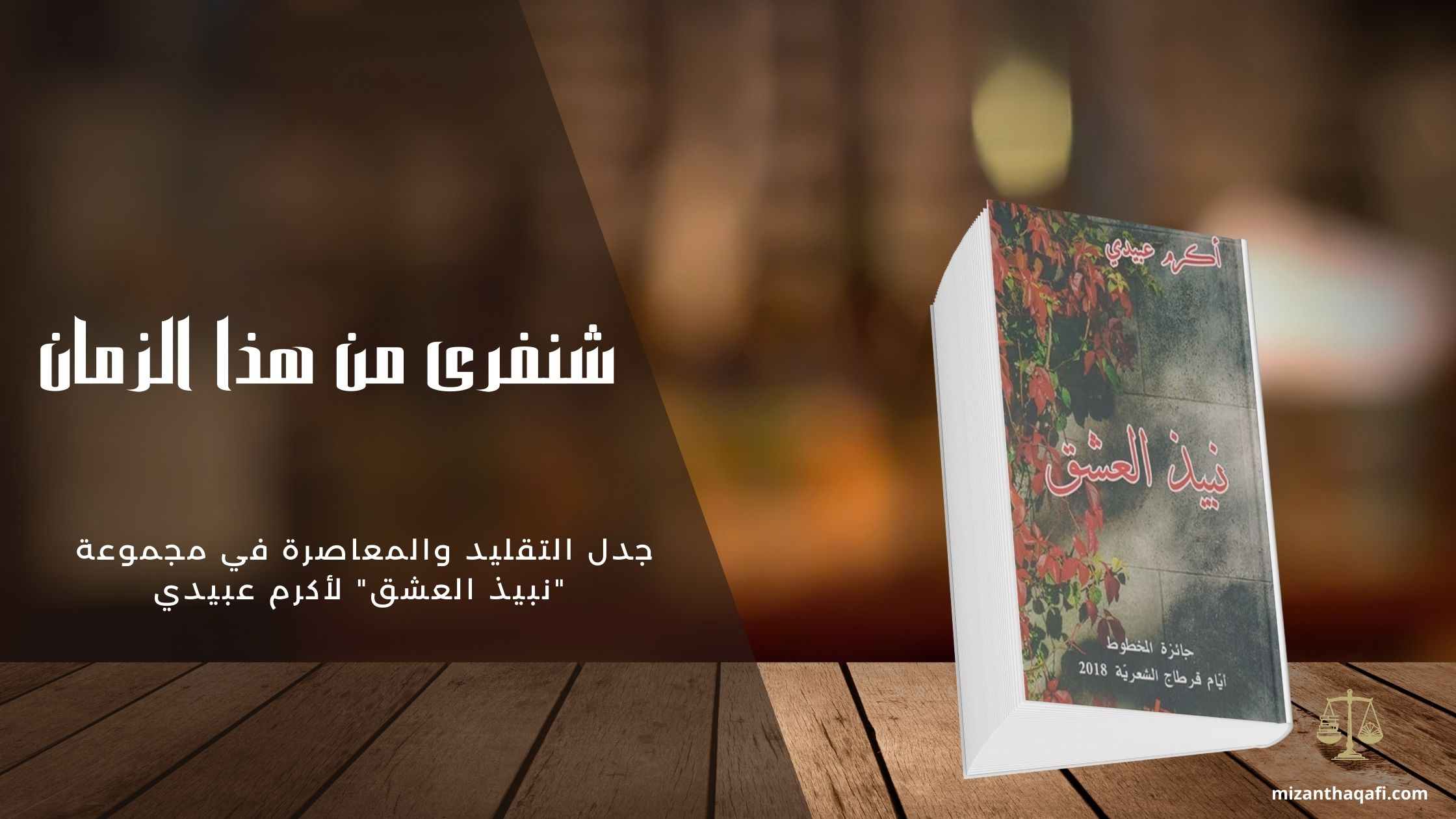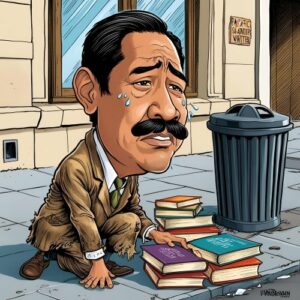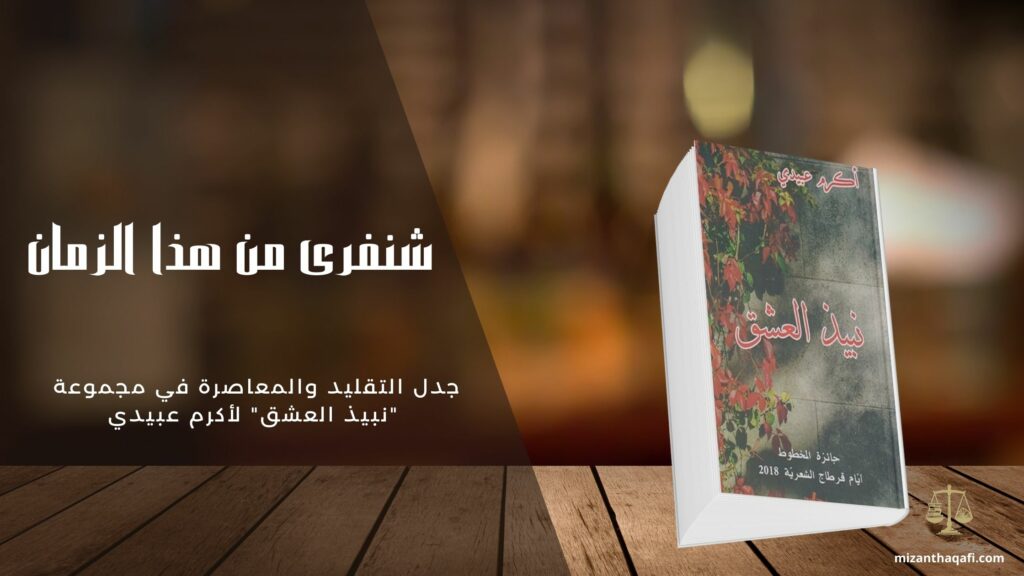
لطالما كان الصراع بين التقليد والتجديد أحد الهواجس الكبرى التي طبعت الشعر العربي. فلئن أرسى القدامى تقاليدهم الشعريّة الراسخة، أو ما اصطلح على تسميته بعمود الشعر، فقد وُجد دائما من الشعراء من يتحدّى تلك التقاليد ويذهب في الشعر غير مذهبهم، ولنا في بشّار وأبي نواس وأبي تمّام أمثلة في عصرهم. أمّا في الفترة المعاصرة، فلم ينقطع هذا الجدل منذ بروز شعراء الإحياء الّذين طرقوا أغراضا لم تكن معهودة في الشعر العربي مرورا بالشعر الرومنطيقي والشعر الحرّ وقصيدة النثر. لعلّ هذا الصراع يصطبغ في وقتنا الراهن بهاجس الحداثة. أرست الحداثة نموذجا جديدا، أو لنقل عمودا جديدا للشعر، لعلّ من سماته الأساسية كسر الوزن التقليدي الموسوم بالبحور التقليدية والاعتناء البالغ بالتخييل ومجانبة التصريح. يمكن القول أنّ هذا النمط ساد على المشهد الشعري منذ التسعينات تقريبا وسار فيه، بدرجات مختلفة، جلّ الشعراء، لكن ذلك لم يمنع من وجود عدد من الشعراء الحريصين على اتّباع السنن الشعرية التليدة.
يطالعنا أكرم عبيدي في مجموعته “نبيذ العشق” الفائزة بجائزة المخطوط في الدورة الأولى لأيّام قرطاج الشعرية سنة 2018 والصادرة عن دار ميارة للنشر والتوزيع سنة 2019 في 96 صفحة ليعلن لنا دون مواربة:
ورحلت عن أهلي ولست بأميَلٍ... وغدوت في هذا الزمان الشنفرى
يجعلنا أكرم نتساءل: هل أنّ الشنفرى خليق بهذا الزمان؟ أو هل أنّ زماننا الآن خليق بالشنفرى؟ وما الذي يعنيه وجود شنفرى في المشهد الشعري الحالي؟ ما الذي يعنيه استدعاء شاعر صعلوك هو صاحب لاميّة العرب في مثل هذا الوقت؟ ألم نتجاوز مع مقولة الحداثة هذا الشكل المغرق في التقليديّة؟
لا يخفي أكرم تمسّكه بالسنن الشعرية القديمة، بل يعلنه على رؤوس الإشهاد في كلّ نصّ من نصوص هذه المجموعة، وكلّها مكتوبة على البحور الخليليّة. ولعلّنا نستغرب هذا الاختيار من شاعر في بداية عقده الثالث، يغنّي الراب ويمارس البريك دانس. ونتساءل: ألا يعيش هذا الشاعر عصره ويعبّر عن هواجسه؟
من خلال قراءة مجموعة “نبيذ العشق”، نرى في أكرم عبيدي شاعرا حريصا كلّ الحرص على اتّباع السنن الشعريّة القديمة من حيث الشكل (المبحث الأوّل) لكنّ ذلك لا يمنعه من أن ينطق عن نفسه وهموم عصره (المبحث الثاني).
1- اتّباع السنن الشعرية من ناحية الشكل في “نبيذ العشق”
يطالعنا هذا الاتّباع منذ العتبة الأولى للمجموعة، وهو عنوانها، ويتأكّد لدينا من خلال بنية القصائد والمجموعة نفسها (أ) وكذلك من خلال أدوات تشكيل القصيد (ب).
- اتّباع السنن الشعرية من حيث البنية
ما أن نمسك بالمجموعة حتّى يعترضنا عنوانها “نبيذ العشق”. لا يكشف هذا العنوان عن مجهود كبير في البحث، وفي الحقيقة يمكن أن نقول أنّه لا يستفزّ القارئ (المحتمل) إلّا قليلا. هو عنوان كلاسيكي للغاية، استعارة لا تتعب الذهن كثيرا. وهذا الإضراب عن البحث في العناوين لا يقتصر على عنوان المجموعة، بل يمسّ عناوين جميع القصائد تقريبا. أغلبها يأتي إمّا في شكل مركبّات إضافية أو نعتية أو في كلمة واحدة أو تأخذ عبارة من نصّ القصيدة نفسها. لا يأتينا عنوان فيه ما يجعلنا نتأمّل قليلا إلّا نادرا، كـ”نقش في الماء” أو “في ظلمة اللا شيء”. كأنّنا بالشاعر لا يعنون إلّا مجاملة أو اضطرارا، ولعلّه لو تُرك لنفسه لم يكن ليعنون المجموعة، ويتركها لتكون “ديوان أكرم عبيدي” ولا ليعنون القصائد.
أمّا إذا انتقلنا من العنوان إلى البيت الأوّل من كلّ قصيدة، فلا نكاد نعثر إلّا على بيت مصرّع، جريا على العادات المتأصّلة منذ زمن المعلّقات. وحتّى البحور التي اختارها الشاعر، فهي عادة البحور التي كتبت عليها مثل هذه القصائد: الكامل (الذي يطغى بشكل كبير) والوافر والطويل والبسيط. كلّها ممّا يقال عليه الشعر الجزل. لا مكان عند شاعرنا للبحور القصيرة التي يقال عليها الشعر تلهيّا. الاستثناءات قليلة في هذا المضمار، كنص “نبض” الذي كُتب على المتدارك المحدث، والذي نرى فيه الشاعر يغالب نفسه (كما سنرى ذلك لاحقا). أمّا الرويّ، فنجد أنّ الشاعر يميل فيه إلى شيء من الاستعراض. فلئن كنّا نجد قصائد على الميم والنون والدال واللام، نرى أنّ أكرم يذهب إلى قواف صعبة الترويض: كالواو والضاد والطاء. وتلك عادة الشعراء الفحول قديما: أن يثبتوا ألّا قافية تستعصي عليهم.
قد يكون الأيسر لشاعر متمسّك بالتقاليد أن يرتّب القصائد حسب الرويّ، كعادة القدامى أو حسب ترتيبها الزمني. ولكنّه لم يختر ذلك، وإن كنّا نجهل تواريخ القصائد. يبدو أنّ تمشّي الشاعر كان مشابها لترتيب السور في المصحف، إذ نلمح مرورا من طوال القصائد إلى قصارها حتى نصل في الصفحات الأخيرة من المجموعة إلى قصائد البيت الواحد، وكأنّنا أمام مقطّعات من حماسة أبي تمّام. بعض هذه القطع قائمة بمعناها، أمّا بعضها فيبدو كبدايات لقصائد لم تتمّ.
أمّا إذا انتقلنا من البنية الكليّة للمجموعة إلى البنية الجزئية، أي بنية كلّ قصيدة من نصوصها، يبدو لنا أنّ ما يطغى على جلّ القصائد قلّة الترابط بين أبياتها. وذلك من المعهود في شعر القدامى، لا سيّما الجاهليين منهم. فكلّ بيت عادة مستوف لمعناه وإذا استرسل المعنى على أكثر من بيت، قلّما لجأ الشاعر إلى التضمين. بل نراه يستعمل في عدّة أحيان العطف ممّا يؤثّر على شعريّة القصيد. وقد نجد أحيانا وحدة معنوية بين عدد من الأبيات تستمّدها من وحدة الموضوع، لكنّ الشاعر يمزّق أوصالها باستطراد يخرج عن موضوعها. مثلا، في قصيدته “قوافي الوطن”، نجد الشاعر يذكر عددا من البلدان العربية (ص 33-34): الشام وفلسطين والجزائر، ثم يخرج عن الموضوع ببيتين عن علاقته بالشعر قبل أن يعود في البيتين الأخيرين إلى ذكر تونس.
ويصاحب هذا الاتّباع للسنن الأولى من حيث البنية اتّباع لها من حيث أدوات تشكيل القصيد.
- اتّباع السنن الشعرية من حيث أدوات تشكيل القصيد
سنعتني هاهنا بالصورة الشعرية والمعاجم التي استعملها الشاعر وهو يشكّل هذه الصورة.
تتنوّع المعاجم المستعملة بتنوّع الأغراض. ولئن طرق الشاعر عددا من الأغراض الشعرية: الغزل، الشعر الوطني، شعر الحكمة… فأنّ ما يلفت انتباهنا معجمان بالخصوص نجدهما يشقّان جميع الأغراض تقريبا وهما المعجم الديني والمعجم الحربي.
أمّا المعجم الديني، فحضوره طاغ منذ بداية المجموعة وإلى آخر صفحاتها: الشرك، العبادة، الصحائف البيضاء، الزكاة، الطواف، الكعبة، الإسلام، الكفر، هاروت، ماروت، بابل، حرام، حلال… كلّ ذلك نجده على امتداد المجموعة. ويوظّف الشاعر هذا المعجم في تناص مع النص القرآني قد لا يكون تبيّنه دائما متاحا للقارئ، ويستصعب تركيبه كقوله:
فإنّي إذا ماتت وجدتُ مقالتي... كما قال في الحشر الذي كبّه الكفر
وهذه الرغبة في إنشاء هذا التناص تجعل الشاعر يذهب أحيانا إلى صور غير مستساغة كقوله:
عيساي أنت وحبّي قد غدا برصا
يذهب الحرص على التناص إلى حدّ تكرار نفس الصورة أحيانا فنجد ذكرا لهاروت وماروت وبابل في قصيدة “بين الصدر والعجز” وفي “بابل” بعبارات تتشابه للغاية.
أمّا المعجم الحربي، فنراه حاضرا لا فقط في الشعر الوطني، بل حتى في الغزل: السيف والقوس والسهم والسلاح والعتاد والكريهة… ومن الطريف أنّنا لا نعثر في ذكر الحرب على سلاح حديث، إلّا مرّة واحدة عندما يذكر الشاعر البنادق في قصيدة “قوافي الوطن”. يقودنا هذا المعجم أحيانا إلى صور نكاد ننفض عنها الغبار كقوله:
بيوم كريهة ساروا لمجد... كأنّ فعالهم كرم وخير
نجد في الصور التي يستعملها الشاعر تقاربا مع الصور الموجودة في الشعر العربي القديم، إلى حدّ يكاد يقترب من التماهي. فإذ يقول عمر بن أبي ربيعة “ويا ليت سلمى في القبور ضجيعتي”، نرى شاعرنا يقول “فيا ليتني كنت التراب أضمّها“. ويلفت انتباهنا في المجموعة أنّ اللجوء إلى الاستعارة، وهي فيما نرى من سمات الحداثة في الشعر، قليل نسبيا في مقابل اللجوء إلى التشبيه. يبلغ ذلك ذروته في قصيدة “قبلة على غبار”، إذ يتكرّر استعمال “كأنّ” في أوّل البيت أربع مرّات في توال يذكّرنا بالأبيات الأخيرة من معلّقة امرئ القيس.
لكنّ ذلك لا يمنع شاعرنا من تجاوز هذه الكلاسيكية في التصوير. إذ يفاجئنا أحيانا بصور أقرب إلى الحداثة، كقوله “يا قاطف الدمع من عيني ومن لغتي” “الموت حرف على ثغري أؤجّله” أو “وكأنّني لمّا رأيت حبيبتي… طفلا يرى ثلجا لأوّل مرّه”، على أنّ مثل هذه الصور تظلّ استثناء. وأحيانا، نرى في الصور شيئا من التعجّل، إذ قد تعترضك من شعر أكرم الصورة التي تقف لديها وتودّ أن تتأمّلها، ولكنّ شاعرنا يسرع مضيّا إلى غيرها، وأحيانا يترك الصورة ناقصة فلا يفيها حقّها كقوله
ما أقبح الأيام تشرب وقتنا... أرأيت يوما واهبا أو مقرضا
فلو قال “تسلب” أو “تسرق” واسترسل في معجم المال لكانت الصورة أتم.
يبدي لنا شاعرنا الكثير من مظهر التشبّث بالقصيدة الكلاسيكية شكلا. غير أنّه يخفي وراء هذا الشكل التقليدي قلبا مهموما بعصره.
2- حضور الآن في مجموعة “نبيذ العشق” مضمونا
نرى حضور الآن في مجموعة “نبيذ العشق” من خلال ملمحين اساسين: التناقض وعلاقة الشاعر بشعره.
- التناقض
إنّ التناقض هو من سمات عصرنا الحالي. إذ أنّنا نعيش الشيء ونقيضه، ونرتبك بينهما خصوصا على المستوى القيمي، فنبقى عاجزين عن الحسم، متأرجحين في انتظار يقين قد يأتي أو لا يأتي.
نجد هذا التناقض حاضرا في شعر أكرم عبيدي في غزله بشكل خاص. إذ أننا نراه في العديد من الأحيان يذهب في الغزل العذريّ إلى اقصى حدوده حتى يبلغ تخوم التصوّف، ويجعل فيه من المرأة كائنا علويا جديرا بالعبادة، إلى حدّ أنّ المرأة تضحي هي من تنفخ الروح، ففي قصيدة “عقد على خدّ” مثلا يقول الشاعر:
أتنفسّ منها اقشعرّت بشرتي؟ أم تنفخين الروح لي في جلدي؟
في أحيان أخرى، تنقلب الصورة، ويصبح الشاعر هو الجدير بالعبادة والحبّ له هو طريق إلى التألّه. انظر قوله:
لولا خشيت الله كنت رفعتها... حتى تنادي في الورى سبحاني
كما نرى الغزل ينقلب من العذريّ إلى الحسيّ، في نفس القصيدة أحيانا، فنرى ذكرا للعناق والقبل واللمسات والوصل. وقد يصاحب ذلك نوع من خيبة الامل في المرأة، تلك التي تقاذفتها الأيدي حتى ضجرت منها وتركتها، كقوله:
يا لوحة أحسنت رسم خطوطها... غيري يمدّ يدي في تلوينها
في حال المرأة المعبودة، نرى تناقضا آخر يبدو للعيان. فبصفة تكاد تكون منهجية، في كلّ مرّة يوصل الشعر المرأة إلى مرتبة الإلهة يُتبع ذلك أو يسبقه بالاستغفار أو الإعلان عن خشية الله، كما في المثال السابق، الذي لو كان منفردا لعددناه تأسّيا بمن ذهب من قبلُ هذا المذهب، لكنّ تكراره بهذا الشكل يعكس خشية حقيقية وصادقة من قبل الشاعر أن يمرق من الدين بسبب ما قاله من الشعر. وهو ما يعكس علاقة إشكالية للشاعر بشعره.
- علاقة الشاعر بشعره
لا تسير علاقة الشاعر بمقوله على نفس الوتيرة دائما، لا سيّما إذا اقترن بالغزل وبـ”شيماء” التي ما تنفكّ تعاود الظهور من قصيدة إلى أخرى، بما قد يوحي بحضور فعلي لها قد يتجاوز الحضور النصّي. دفعت المحبوبة الشاعر إلى الخروج من إطاره المحبوب، أي الشكل التقليدي للقصيد، ليكتب ما يشبه أشعار نزار قبّاني في قصيدته “نبض”. غير أنّ هذا الخروج عن المألوف يتّصل بردّ فعل حاد. في الأبيات الثلاث الأخيرة من هذا النص، نجد حضورا مهولا للقيد ومرادفاته (الصفد، الأسر، المأسر) يتكرّر ثماني مرّات. وكأنّنا بالشاعر يثور على ما جعله غير نفسه… تكرار هذا المعجم لافت للانتباه، وخاصة لفظ “صفد” الذي نراه مبثوثا في عدد كبير من القصائد، معبّرا عن قيد يعيشه الشاعر، ولكنّه ليس ككلّ القيود. في قصيدته “جناح القصيدة” التي يخصّصها الشاعر لعرض رؤيته للشعر نجد الأبيات التالية:
يطير الشعر، ليت الشعر يبقى... وليت الشعر يرسل لي جنوده
فتأخذني أسيرا، هل أسير... إذا ما كنت مصفودا قصيده
أرى صفد القصائد لي سوارا... وتاج الشعر لي دررا تليده
الشعر قيد، ولكنّه في نفس الوقت سوار يميزّ الشاعر ويجعله يتيه على العالمين. الشعر جناح الشاعر ليصل إلى ما لا يطاله واقعا: فيضحي الشاعر يكتب القبل (في قصيدة مسيلمة الصدّيق) الشعر رفيق الشاعر في غربته (بمعنييها الحسّي والمجازي) فيضحي القلم صوت يأسه (قصيدة وساوس). الغربة التي تؤدّي إلى موت القلب فلا يكون العزاء إلّا في القلم (قصيدة إجازة). وقد يضحي الشعر نفسه هو عنوان الغربة. الشاعر يعيش في عزلة عن عالمه منقطعا إلى الحرف:
مازلت متّخذا من خلوتي جسدا... والروح أسكنها في قطرة الحبر
غير أنّ شاعرنا قد يضيق ذرعا من ذلك، وتعييه تلك الغربة ويودّ لو يتجرّد من شعره، لكن كيف يخرج المرء عن نفسه:
كرهت كتابة الأشعار لكن... أرى قلمي يجيد الانزلاقا
ويصل ضيق الشاعر من شعره حدّ أنّه يرى أنّه يعجز تماما عن استيعاب ما يعتمل داخله:
لا لفظ يشبع أحرفي أن تعرضي... لا حرف يروي صرخة كالرعد
ولكن يظلّ الشعر على ذلك ولادة متجدّدة تنتشل الشاعر من الموت الذي يديم ذكره في عدّة قصائد. الشعر حياة جديدة: أو ليس إنجاب القصيد تمخّضا (في قصيدة في ظلمة اللاشيء)
لعلّ تأمّل هذه العلاقة المركّبة التي تربط أكرم عبيدي بشعره مفتاح لقراءة ديوانه بشكل مختلف. إذ ليس الشكل التقليدي الذي اختاره إلّا رداء يخفي نفسا قلقة تحيط بها الهواجس والشكوك، كما يجدر بمن يعيش في مثل عالمنا هذا. هو شاعر يكتب القصيدة الكلاسيكية في أعرق صورها لكنّه يرتاب في جدوى الحرف دون أن يمنعه ذلك من أن يواصل الكتابة. مثلما كان الشنفرى غريبا في قومه يعيش بقيمه الخاصة وسط مجتمع ينكره، يغترب أكرم عبيده بشعره المعتّق نافرا من الحداثة وتجلّياتها باحثا في طيّات الحروف عن شيء من نفسه…
*فاز هذا المقال بالجائزة الأولى في مسابقة النقد في الملتقى الوطني للإبداع الأدبي والفني المنعقد في دورته 18 بالقيروان من 17 إلى 19 ماي 2024