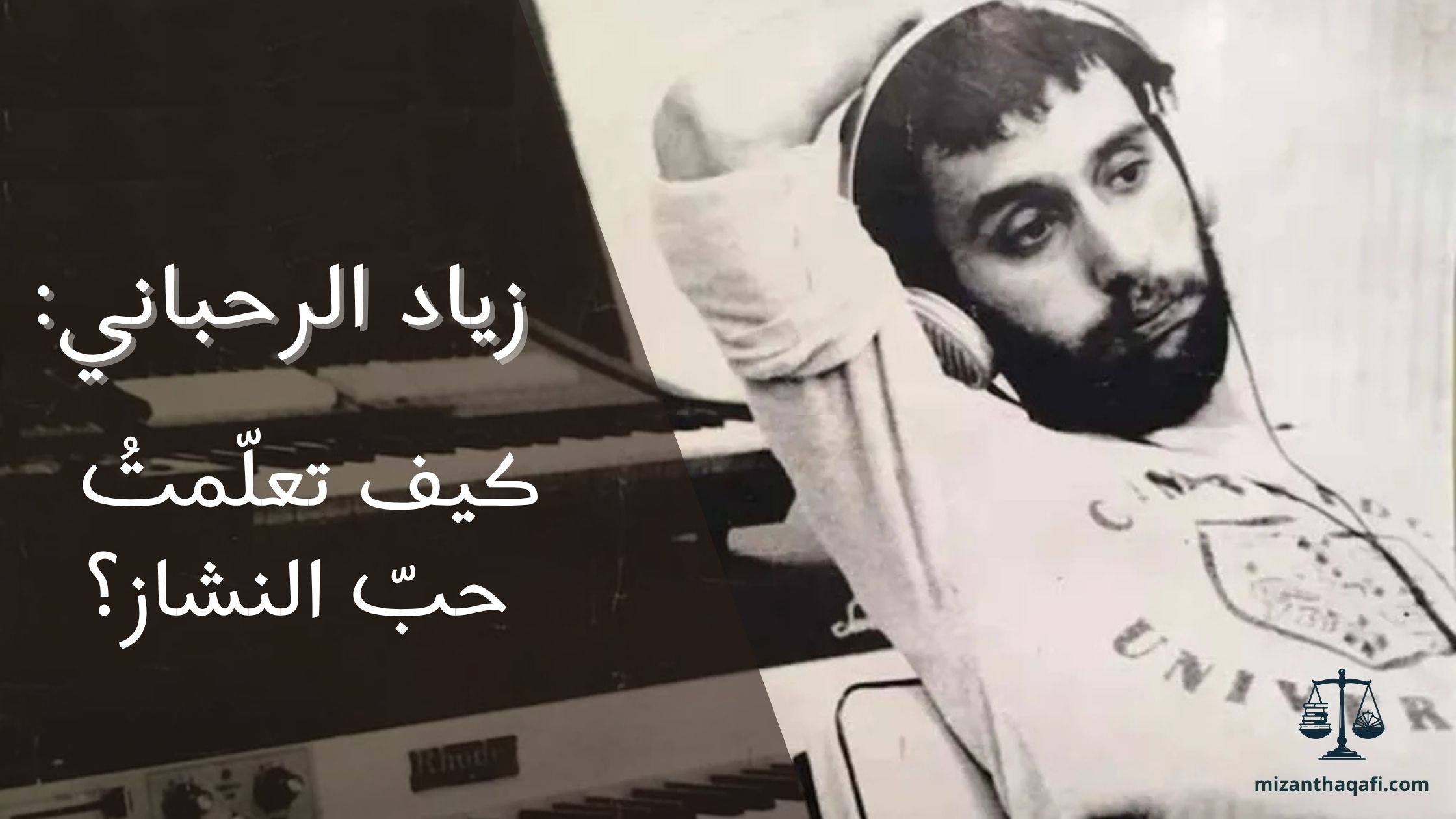لم أكن أحبّ زيادا الرحباني في البداية. كُنتُ أراه نشازا يُشوّش الصورة التي كنت قد شيّدتها حول فيروز والرحابنة، صورة تتعالى عن صخب الواقع ومآسيه. تطلّب منّي الأمر الكثير من الوقت لأتلمّس إيقاع النشاز ومنطقه. ولم ألبث بعدها أن اعتنقتُ هذا النشاز لمّا اكتشفتُ أنّه صدى ما كنت أرفض رؤيته في داخلي. كان النشاز ظلّي الذي يعدو ورائي.
زياد الذي كرهته
تعرّفت على زياد الرحباني في نفس الوقت تقريبا الّذي تعرّفت فيه على فيروز. كُنت في بدايات المراهقة وسقطتُ، مثل آليس، في بلد عجيب كلّ ركن فيه مصنوع ببراعة فائقة ويعكس نقاء لا مثيل له. وسرعان ما أعلنتُ نفسي مواطنا في هذا البلد، عالم فيروز الرحابنة.
لم أكن أتّبع في سيري في هذا البلد طريقا محدّدة. لم يكن كلّ شيء ملقى على قارعة الطريق كما هو الآن لا يحتاج إلّا نقرة زرّ. كُنت أبني معرفتي الموسيقية ببطء، شريطا بعد آخر. دينار واحد كان ثمن كلّ رحلة من هذه الرحلات. كنتُ أقتني كلّ ما أجده بشكل اعتباطي، دون أعرف موقعه من مسار فيروز الموسيقي. وشاءت الأقدار أن يكون ثالث شريط أقتنيه (بعد شريطين أظنهما مختارات لأغانيها) شريطا يحمل عنوان “مش كاين هيك تكون”. لم أكن أعرف وقتها أنه أحدث أشرطتها وأنّه صدر في نفس السنة (1999). استمعتُ إلى الشريط معجبا خصوصا بالقصائد المغناة التي احتواها. لكنّ هناك أغنية فيه أربكتني، وهي التي تحمل نفس عنوان الشريط. لم أفهم ما يرادُ بها، وبدت لي عباراتها مبتذلة. أبيتُ أن أصدّق، وقلت أنّني لا شكّ لم أفهم، وأنّها تحتوي على معان لم تنجل لي. وضعت الأغنية بين قوسين، وواصلت رحلتي في اكتشاف عالم فيروز.
لم أتلمّس توجّه الأغنية إلّا بعد أشهر، لمّا قرأت مقالا في جريدة أسبوعية حول حفل فيروز في بيت الدين سنة 2000. كان المقال ينتقد بشدّة التوجّه الّذي أدخله زياد الرحباني على مسار فيروز، ومن معالمه “دفعها” لأداء أغان دون مستواها المعهود بكثير وتوزيعه الغريب عن تقاليد الموسيقى العربية. حينها ظننت أنّني فهمت ما غاب عنّي: ليست المشكلة في فيروز، فهي صرح لا تطاله الأيدي، وإنّما فيمن يريد إسقاطها من سمائها. حينها جعلتُ من زياد عدوّا لي، كيف لا وهو يشوّه ذلك العالم المثالي الّذي آمنتُ به بكلّ جوارحي.
التناقضات وبدء التحوّل
لم يمنعني ذلك من الوقوع في تناقضات في علاقة بهذه العداوة. لم أستطع أن أمنع نفسي من أن أُعجب بعدد من أغاني زياد، كـ”حبيتك تنسيت النوم”، “أغنية الوداع”، “عودك رنّان” (وإن لم أحبّذ توزيعها الأصلي)، ولعلّ روحا فيها من فيروز الأولى كان يجذبني إليها. على أنّني كذلك انجذبت إلى “البوسطة”، تلك الرنّة وسط الزحام، وطربت لـ”يا ليلي ليلي”، ذلك الكرنفال ذي الكلمة الواحدة. إلّا أنّ هذه الإعجاب (الظرفي) لم يمنعني من نسيان التناقض الأصلي: زياد عدوّ عالمي المثالي. أذكر أنّي، ما إن تعلمت الإبحار في الانترنت، كتبت في منتدى لأحبّاء فيروز داعيا إيّاها إلى الاعتزال حتّى لا تشوّه مسيرتها بمثل ذلك العبث.
ظللت على موقفي ذلك لعدّة سنوات. حين توفّي منصور الرحباني في 2009، كتبتُ أنعى الوطن الرحباني وآسف لحاله، زاعما أنّ زيادا ارتكب جريمة ضدّ الإنسانية بما فعله بذلك الوطن، إذ حرمنا من ذلك الرابط الرقيق الّذي ظلّ يشدّنا إلى السماء. لم أكن أعلم حينها أنّني أنا نفسي كنتُ في نهاية مرحلتي المثالية. في ذلك العام، كُنتُ أنهي مشواري الدراسي وأدخل الحياة العملية. بدأتُ مساري المهني باستقالة، وصاحبت ذلك خيبة شخصيّة مريرة. كنتُ أحسّ أنّ الأبواب توصد في وجهي، فحاولت استمطار السماء، لكنّها لم تكن لي عونا. السماء كانت تدعوني أن أتسامى وأن أتعالى، أي ألّا أكون إنسانا. وجاء زياد…
لا أذكر تحديدا كيف غرقتُ في عالمه. أظنّني بدأت بإعادة تقدير زياديات فيروز، واكتشفتُ، فيما يشبه لحظة الإلهام، أنّها تعبّر عنّي في أغلب الأحيان بشكل أفضل بكثير من رحبانياتها. بدأتُ أتذوّق أغان من طينة “كبيرة المزحة هاي” و”تنذكر ما بتنعاد”. وفي غمرة ذلك، نشرت مجلة الآداب البيروتية ملفا مميّزا ومفصّلا عن مسيرته حمل عنوان “زياد الرحباني… صائد التحولات والانكسارات”. انكببت على ذلك الملفّ بنهم، قارئا لنصوصه عدّة مرّات. صحب ذلك عمل كبير على الانترنت في مختلف المواقع والمنتديات، فلم يمض العام إلّا وقد كُنتُ جمّعتُ (تقريبا) كلّ ما أنتجه زياد طوال مسيرته، أو على الأقلّ ما نُشر منه. وعلى مدى عامين تقريبا، كانت أعمال زياد هي أكثر ما أستمع إليه، حتى فاق استماعي إليها استماعي إلى فيروز حينها.
كان زياد الرحباني هو من جسّر علاقتي بالواقع. لطالما كنتُ أنظر إلى الواقع من علٍ محاولا الهروب منه عبر العيش وفق مُثُل عليا، ولم تكن فيروز وعالم الرحابنة إلّا تجسيدا لها. كُنتُ مثل الصوفيّ الذي يريد البقاء إلى الأبد في حالة التجلّي، وهذا ما كانت تأباه الحياة. حينما تعرّضت إلى اختباراتها بشكل فعليّ، وجدت أنّ مرجعياتي القديمة قاصرة تمام القصور عن مواجهتها. وكانت هناك حاجة إلى مرجعيات مغايرة تعترف بالحقيقة وتتعامل معها ببساطة. لم أعد أحتاج مثلا إلى أسطرة بدايات الحبّ بالقول “من يومها صار القمر أكبر”، بل أعترف أنّ “معرفتي فيك إجت ع زعل”. وأمام خيباته، لم يعد يغنيني القول “وتسكّر القلب ما وقع ولا نجمة”، بل أحتاج إلى أن أصرخ “واذكري بس شو كنت بهيم معك”.
في فهم زياد
مفهوم الخيال الشعري لم يكن له معنى كبير عند زياد، عكس الرحابنة الكبار الّذين يصوغون كلمات أغانيهم بعناية فائقة. عباراته كلّها نابعة من المعيش اليومي، غير مقنّعة بقوالب لغوية معقّدة. شعريّته هي شعريّة الحياة نفسها، كما تأتي، دون مواربة ودون تجميل. هي قريبة من النفس، تجد نفسك تتمثّلها دون أن تشعر. قد لا تصعد بك إلى ذرى جمالية عالية، لكنّها تعبّر عنك في حالتك الخام بكلّ اضطراباتها وارتباكها وعفويتها.
لم يكن زياد يعتبر الصوت أكثر من “آلة” كبقية الآلات في تركيب الأغنية. تحدّث في بعض حواراته أنّه لم يكن يحتاج إلى مغنّين بقدر ما يحتاج إلى مؤدّين. لا تهمّ نوعية الصوت كثيرا، بقدر ما تهمّ قدرته على أداء الحالة الّتي تعبّر عنها الأغنية. ينزاح المغنّي إذن إلى ما يُشبه دور الممثّل إذ يسعى إلى تجسيد حالة ما بصوته. حتّى الكلمات لا تعود ذات معنى كبير لإيصال هذا الشعور، وقد يُضحّى بها وبتناسقها إذا لم تضف شيئا كبيرا إليه. مثلا، في توزيعه لأغنية “يارا”، يتخلّى زياد عن جزء كبير من الكلمات، من المفروض أنّه ضروريّ لفهم علاقة يارا بأخيها، ويستعيض عنه بأداء فردي للساكسوفون، قبل أن تعود فيروز في لتغنّي العبارة الختامية.
كانت لزياد فلسفة مفادها أنّه يمكن مقاربة موسيقات العالم كلّها بروح شرقية. اخترع في الثمانينات مفهوم الجاز الشرقي، وإن يكن تخلّى عن هذه التسمية فيما بعد (معتبرا أنّ الجاز هو الجاز في كلّ مكان)، إلّا أنّه حافظ على هذه الفلسفة. في حفل “بهالشكل” سنة 1986، نستمع مثلا إلى مقطوعة Round Midnight لثيلونيوس مونك محتوية على عزف على العود. نجد هذه الروح حاضرة حتّى في المقطوعات ذات التوزيع السمفوني، كمقدّمة بيت الدين مثلا. لا شكّ أنّ الأخوين الرحباني كانا سبّاقين إلى استلهام الموسيقى الغربية في أعمالهما منذ الخمسينات، إلّا أنّ توليفة زياد كانت مختلفة. عاصي ومنصور كانا يقتبسان، من موقع الغريب المُستطرِف، أمّا زياد فكان يلقي بنفسه في المعمعة، محافظا على روحه.
زياد بين النبوغ والتمرّد
بمحاذاة هذا الجانب الفنّي، كان هناك جانب شخصي جذبني إلى زياد، وهو يتجلّى أساسا في بُعدين: نبوغه المبكّر وروحه المتمرّدة. كان يذهلني ما أمكن له أن يفعله قبل بلوغ العشرين: أصدر مجموعة شعرية وهو في سنّ الثانية عشرة، لحّن لهدى حدّاد وهو في سنّ الخامسة عشرة، لحّن “سألوني الناس” لفيروز وهو في سنّ السابعة عشرة وعرض مسرحيته الغنائية الأولى “سهرية” في نفس السنّ، كتب مقدّمة “ميس الريم” في سنّ التاسعة عشرة، وكان له برنامج إذاعي ناجح “بعدنا طيبين… قول الله” في سنّ العشرين. وتتالت بعد ذلك أعماله الغنائية والمسرحية والإذاعية حتّى أنّه لمّا بلغ الثلاثين، كان له مُنجز إبداعي يمكن له أن يملأ مسيرة عمر بأسره. وأكاد أجزم أنّ هذا النبوغ أصبح في فترة ما عبئا عليه. كطائر القطرس (Albatros) في قصيدة بودلير، منعه جناحاه العملاقان من المشي. كان يريد من الزمن أن يبلّغه ما ليس يبلغه من نفسه، فيما كان الواقع المرّ يحاصره من كلّ جانب…
أمّا روحه المتمرّدة، فيعبّر عنهما أثره نفسه. كان بإمكان زياد بسهولة أن ينصّب نفسه وريثا شرعيّا للأخوين فيسير على نهجهما ويحاكي منجزهما. أثبت أنّ ذلك في مقدوره في أعمال من طينة “حبّيتك تنسيت النوم” و”ما قدرت نسيت”. كان ذلك ليكسبه رضا الجماهير والنقّاد، إلّا أنّه لم يكن قطّ ممّن يبحثون عن الرضا، بل سار في النهج المخالف تماما. كانت مسرحيته “شي فاشل” (1983) نوعا من التفكيك الساخر للمُثُل الرحبانية عن وطن لم يوجد قطّ إلّا في أذهان من تخيّلوه. هذه المسرحية تكاد تكون نموذجا يعرضه الأخصّاء النفسانيون حول مفهوم قتل الأب. أمّا أغنية “مش كان هيك تكون”، الّتي لم أفهمها صبيّا، فكانت محاكاة تهكّميّة لنمط الكتابة الرحباني، وهو ما جلب له نقمة النقّاد حينها، وهي نقمة لم يلق إليها بالا إذ أعاد الكرّة في أغنية “لا والله” بعد ثلاث سنوات.
هذان البعدان فاضا في تلك المرارة التي يمهر بها أعماله. هذه المرارة قد تكون من صميم العمل نفسه، كما في حبكة مسرحيتي “بالنسبة لبكرا…شو” و”فيلم أمريكي طويل”. وقد تتجلّى كذلك في الطابع الساخر الموجود بقوة في برامجه الإذاعية ومقالاته الصحفية والحوارات الّتي يجريها، فضلا عن سائر أعماله الإبداعية. قد نضحك لتعابيره الساخرة لكن نخطئ إن ظننّا أنّ المقصود بها هو الإضحاك. هي مرارة قاتمة من شخص لم يرض بالواقع وعمل على تغييره فوجده لا يتزحزح من مكانه. في نهاية المطاف، ورغم محاربته لمثاليات الأخوين الرحباني، آل زياد إلى تكوين مثاليته الخاصة به، رغم أنف الإيديولوجيا اليسارية الّتي كان يحملها، والتي من المفروض فيها نظريا أن تكون نابعة من الواقع. لعلّ التزامه بها كان أكثر جوانبه إثارة للجدل لا سيّما في سياق معقّد كالسياق اللبناني. قد لا نتّفق مع جميع آرائه، لكن حسبه أنّ بوصلته كانت واضحة: الانحياز للكادحين وللمقاومة.
زياد المغترب
هذا التناقض الفادح بين الواقع والمنشود أثّر على إنتاجيّته بشكل واضح. قلّت وتيرة أعماله في التسعينات، وما أن بلغنا الألفية الجديدة، حتّى صارت أعماله أكثر نُدرة. وحتّى فيما كان ينتجه، لم تكن روحه بارزة فيها كما كانت من قبل. هو نفسه يعترف أنّه قبل ببعض الإنتاجات لأنّه مضطرّ أن يعمل. كان من الواضح أنّه ضاق ذرعا بما يحيط به وأنّ الضجر يسيطر عليه. في ذلك، كان زياد يحمل جميع سمات الاغتراب. هو يعبّر عن ذلك، منذ كان يشتغل على برنامج “العقل زينة”، بقولته:
أنا ما عم جرّب غيّر البلد، ولا عم جرّب غيّر شي. أنا عم جرّب بس ما خلّي هالبلد يغيّرني. هيدي وحدها اذا بتضبط معي يعني انتصار… انتصار لنفسي أولًا.
في هذا الاغتراب، كُنتُ ألتقي مجدّدا مع زياد. لم يكن لديّ نبوغه ولا تمرّده، وهما ما كانا يرسمان لي أفقا أرنو إليه، ولكن كنت أشترك معه في عدم الرضا بالواقع مع العجز عن تغييره. كان وجوده في ذاته كافيا لأحافظ على إيماني أنّ تغييرا ما يظلّ ممكنا. حتّى مع ندرة إنتاجاته، كان يثبت في إطلالاته أنّه قادر دائما أن يأتي بالجديد، مثلما فعل مع “إيه… في أمل” سنة 2010.
كُنتُ أخطّط للكتابة عن زياد منذ عشر سنوات أو أكثر، ولم أفعل. لا أدري تحديدا لم، لكنّني على الأرجح كُنتُ أنتظر رجوعه بمشروع كبير يُثبت لي أنّ الأمل موجود فعلا. هو، ذلك العبقريّ الّذي تعوّد أن يفاجئنا كلّ مرّة وهو يسلك طريقا غير مألوفة. أظنّني كنتُ أنتظر لأكتب عن جديده، لا أن أتحدّث عن أثره بصيغة الماضي. لم أكن أدري أنّ الجديد الوحيد الّذي تبقّى له هو رحيله… لم يكن هناك أمل إذن. لعلّ هذه هي سخريّته الأخيرة.
لم أملك إلّا أن أردّد العبارات التي قالها هو نفسه في توديع جوزيف صقر:
مات وعطاني عمرو… أنا عمرو شو بدي فيه ؟
أنا العمر اللي عليي مش عارف كيف كفيه